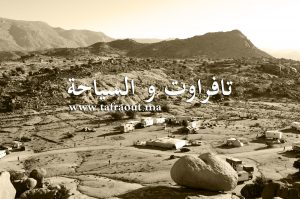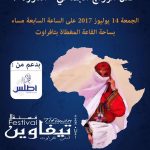فاعلون أمازيغيون يلتئمون بالرباط في ندوة حول القانون التنظيمي للأمازيغية
في إطار سلسلة لقاءات شهرية حول الأمازيغية وقضاياها الراهنة، نظمت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بمقرها المركزي بالرباط ندوة حول موضوع “القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، وذلك مساء يوم الجمعة 92 يونيو 9109 من الساعة السادسة والنصف مساء إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. وحضرها، إضافة إلى أعضاء من فروع الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي )من فروع الرباط، الدار البيضاء، تمارة وسلا(، أعضاء من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة )أزطّا أمازيغ( وباحثون من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأعضاء من منظمات حقوقية )المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان( وأعضاء من جمعية تاماينوتوطلبة جامعيون من الحركة الأمازيغية )موقعي الرباط ومكناس( ومناضلون في الحركة الأمازيغية من مختلف المواقع والمنابر الإعلامية والسياسية والثقافية والتنموية والفنية.
وقد شارك في هذا اللقاء مجموعة من السادة الأساتذة الممثلون لمختلف تيارات وإطارات الحركة الأمازيغية والمهتمون بمختلف جوانب موضوع الندوة السياسية والحقوقية والقانونية والأنتروبولوجية واللغوية وهم حسب ترتيب التدخلات:
الأستاذ علي خداوي: من مؤسسي مجموعة الاختيار الأمازيغي، حول موضوع: “البعد السياسي للقوانين التنظيمية في الدستور الجديد”؛
الأستاذ أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، حول موضوع: “القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، أية منهجية وبأي محتوى”؟ ؛
الأستاذ الصافي مومن علي: عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، بموضوع: “حول مقتضيات القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغي”؛
الأستاذ عبد السلام الخلفي: باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حول موضوع: “من أجل تدبير معقلن للتعدد اللساني بالمغرب”.
الأستاذ أحمد عصيد: عضو المكتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، حول موضوع: “الأوراش الكبرى لما بعد الترسيم”؛
وزيادة على طابعها الفكري، فقد اتخذت هذه الندوة مسار بداية حوار بين مكونات الحركة الأمازيغية حول تصورها للقانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، ومستقبل الأمازيغية بعد ترسيمها في الدستور.
لقد تناول السادة الأساتذة؛ كل من خلال الموضوع الذي اقترحه وفي إطار الوقت المخصص له ) 91 دقيقة( وبكثير من التركيز والعمق وبدون تكرار لما ورد في باقي المداخلات؛ مختلف الجوانب القانونية والسياسية والتنظيمية التي يستلزمها التنزيل الديمقراطي للقانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية مع الإحالة على مسؤوليات كل طرف من الأطراف المعنية بهذا التنزيل )مؤسسات تشريعية وتنفيذية وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا وبالخصوص منهم الحركة الأمازيغية(. ولقد أعقبت هذه المداخلات مجموعة من تدخلات الحاضرات والحاضرين، كانت بدورها مركزة وعميقة شكلت قيمة مضافة لمداخلات السادة المحاضرين، وسنحت لهؤلاء في نفس الوقت بأن يتناولوا باقي الجوانب التي لم يتمكنوا من مقاربتها أثناء إلقاء عروضهم. وفي ما يلي ملخص مقتضب عن أشغال هذا اللقاء.
أولا: مداخلات السادة المحاضرين:
? بخصوص موضوع: “البعد السياسي للقوانين التنظيمية في الدستور الجديد” استهله الأستاذ علي خداوي بالإحالة على مرجعيتين لا مناص لكل من يريد أن يربط بين السياسة وتدبير المجتمع من العودة إليهما؛ وهما المرجعية الفلسفية و المرجعية الأنتروبولوجية.
فبصدد الأولى ذكّ ر بما قام به أرسطو إلى جانب الإسكندر المقدوني خاصة في ما تركه لنا من خلال كتابه “السياسي” (Le Politique) ؛ كما أشار السيد المحاضر، من الناحية الأنتروبولوجية، إلى ضرورة وضع مشروع مجتمعي متفاوض عليه في كل محاولة سياسية تستهدف إحداث تغيير وتقدم في مجتمع مّا؛ وإلا فمصير تلك المحاولة الفشل الدريع.
وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ الأستاذ علي خداوي كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لا تفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات؛ مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا إلى مجموعة من المحطات التاريخية والسياسية التي تدعم تأكيد هذا بدءا بتضحيات
الأمازيغ منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن، يضيف السيد المحاضر، توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية، بل إنها عملت وتعمل على إفشال الإرادة الملكية في هذا الشأن. ويبدو أن البديل، يضيف الأستاذ، لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة
المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية.
ثم انتقل إلى معالجة البعد السياسي للقضية الأمازيغية في الدستور الجديد لكي يؤكد أيضا على أن شكل التنصيص عليه لا يرقى إلى مستوى طموحات الأمازيغ وكل المدافعين على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية والبيئية؛ خاصة وأن الأمازيغية ينبغي أن تعالج في شموليتها بحيث تشمل هذه المعالجة مختلف الأبعاد اللغوية والثقافية والهوياتية والحضارية. وذلك لأن الأمر الواقع، الذي نحن أمامه، هو عدم تمثيلية الأمازيغ تمثيلية منصفة في المؤسسات التي تقوم بتدبير الشأن الأمازيغي، هذا إضافة إلى استمرارية ممارسة سلوكات الميز والتهميش في كثير من الأحيان تجاه الأمازيغ والأمازيغية؛ بل إن اعتقال المناضلين الأمازيغ يفتقر في كثير من الأحيان إلى محاكمات عادلة.
كما أن الاعتراف بالأمازيغية يفتقر إلى مشروع مجتمعي متفاوض عليه ويخلو من كل السلبيات التي تمت الإشارة إليها أعلاه؛ الشيء الذي ترتب عنه نفور الأمازيغ من الانخراط في العمل السياسي في الوقت الذي ساهمت الحركة الأمازيغية، منذ نشأتها، في بلورة خطاب ثقافي وسياسي ديمقراطي وحداثي يستهدف الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
? وبخصوص موضوع : ” القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، أية منهجية وبأي محتوى ” ؟ أكد الأستاذ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد ” أمام أمر واقع ” لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية . واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات
السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منها الفصل 21 و 21 . و 21 و 21
وبعد استعراض محتويات التصريح الحكومي الذي يستشف منه توجه الحكومة الحالية وأولوياتها، بتراتبية تجعل الأمازيغية في مستوى اذنى من غيرها، والذي ليس جديدا سواء قبل التصويت على الدستور المعدل أو أثناء التفاوض عليه مع القصر أو بعد التصويت عليه؛
قدم السيد المحاضر خطة عمل، على الحركة الأمازيغة للعمل بها لكي تواجه بها هذه المناورات سواء منها الواضحة أو الخفية؛
ومن بين عناصرها: واجهة منطق الإتكالية والإنتظارية والإكتفاء بالإدانة والرفض لكل المناورات، عبر الإنتقال الى العمل بالتركيز دورنا كقوة اقتراحية و الترافع من أجل تبني ديمقراطي للقانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية . وأشار إلى أن موقفه الشخصي الذي يتبناه، في هذا الصدد، هو اقتراح وتبني قانون تنظيمي ترضاه الحركة الأمازيغية وتريده .
ثم انتقل بعد ذلك إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي ينبغي استحضارها في كل عملية تفعيل نريده ونرضاه، وتكون من شأنه الاستجابة الحقيقية للمطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ أكثر من أربعة عقود . وأول هذه الأسئلة هو سؤال المرجعية الذي يجب ان يتمثل في عمق الحضارة الأمازيغية وعراقتها؛ وثانيها سؤال مرجعية حقوق الإنسان؛
وثالثها سؤال تجارب شعوب أخرى ذات نفس الوضع الذي يوجد فيه الأمازيغ والأمازيغية او غيرها مع تفادي أسلوب الإستنساخ؛ ورابعها سؤال القانون التنظيمي الذي تريده الحركة الأمازيغية وترضاه . ثم أردف وطرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع ذاته متسائلا :
أ ? هل نحن مجبرون دائما على انتظار من يتخذ الموقف بدلنا ويقترح لنا عوضنا؟
ب ? هل من مهمنا انتظار أطراف سياسية حكومة او غير حكومية تقدم لنا مشروعا عوضنا؟
ج ? أ غيرنا هو الذي سيقرر في الأولويات التي تصلح لنا؟
د ? ألا يمكن أن نفكر في مشروع مجتمعي او “دستور للأمازيغية” نقترحه على المؤسسات والأطراف المعنية به ؟
ه ? ألا يمكن أن يعتمد مقترح تضعه منظمات غير حكومية؟
بعد هذه الأسئلة والتساؤلات يلفت السيد المحاضر النظر إلى بنية الفرص المتاحة والمتمثلة من جهة في ضرورة وجود مناخ انفراج سياسي في ملف الأمازيغية و داخل الحركة الأمازيغية، ومن جهة أخرى إمكانية اختراق الوثيق ) وثيقة الدستور ( وجعل المجتمع المدني يلعب دوره التاريخي والمسؤول وعدم التعامل مع المنطوق اللغوي للوثيقة الدستورية فقط وذات الصلة بالجوانب اللغوية؛ بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى كل الجوانب والمجالات المختلفة للأمازيغية؛ وذلك انطلاقا من استحضار مجموعة من المحاور أهمها التربية والتعليم والتكوين ومنظومة العدالة ومنظومة الإعلام واستحضار مجموعة من المحتويات أهمها : الجوانب الموضوعاتية والجوانب المؤسساتية ومجموعة من آليات التدبير .
ليختم تدخله بالتأكيد على أن القانون التنظيمي ليس مجرد أي صياغة قانونية بل يتعداها ليكون فضاءا يلامس كل جوانب الحياة العامة الموضوعاتية منها والمؤسساتية؛ وفي هذا السياق يستلزم الأمر التفاعل مع ذوي الاختصاص والكفاءة واستحضار مجموعة من المحاور والمحتويات التي تمت الإشارة إلى بعضها أعلاه واقتراح بدائل مؤسساتية وفاعلة
قادرة على تحمل المسؤوليات السياسية والأكاديمية للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
3 ? أما في ما يتعلق بموضوع: “حول مقتضيات القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغي”؛ فقد اعتبر الأستاذ الصافي مومن علي الفصل الخامس من الدستور بمثابة قطعة ذهبية في يد الحركة الأمازيغية التي عليها أن توظفها لتقوية مكانة الأمازيغية. ليشير بعد ذلك إلى أنه كان، مباشرة بعد التصويت على الدستور، من بين الذين يستعجلون تنزيل القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية. ولكن بعد تحليل عميق لنص الفصل الخامس فقد تبين له أن التنزيل الصحيح والسليم لهذا الفصل يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أربعة أمور هي:
أ ? تحديد ميدان التطبيق،
ب ? تحديد المجالات العامة،
ج ? تحديد كيفية إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة،
د? تحديد مراحل التفعيل.
كما أكذ على أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار؛ في عملية إدماج الأمازيغية في مختلف هذه المجالات؛ معيارين أساسين وهما: معيار الأولوية ومعيار السهولة في الإنجاز وقلة التكاليف. فبالنسبة لمعيار الأولوية لا بد من استهداف المجالات العامة ذات الأولوية، ولا مانع من أن يتوجه التنزيل إلى كافة المجالات كما لا يمكن ترسيم أية لغة بدون إدماجها في التعليم والإعلام. أما بالنسبة لمعيار السهولة في الإنجاز وقلة التكاليف فينبغي التمهيد للمستقبل، بدءا بما هو أسهل في الإنجاز. وبعد ذلك قام السيد المحاضر بعرض مجموعة من المقترحات العملية التي تستجيب لهذا المعيار بكثير من التفاصيل والتدقيقات، مستعرضا مختلف المجالات المعنية بتنزيل القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية وفق ما يتطابق وهذا المعيار الأخير. واسترسل في تفصيل بعض الجوانب التي ينبغي أن يشملها القانون التنظيمي بدءا بالتعليم والإعلام ووصولا إلى مختلف مجالات الحياة العامة من صحة وقضاء وشؤون إسلامية وعلامات
طرقية )التشوير( إلى غيرها من المجالات.
? وأما في ما يتعلق بموضوع: “من أجل تدبير معقلن للتعدد اللساني بالمغرب”. فقد استهل الأستاذ عبد السلام خلفي عرضه بالسياق العالمي حيث أبرز كيف أنه نتيجة للسياسات اليعقوبية التي باشرتها الدول القومية منذ القرن التاسع عشر؛ والاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية من طرف الدول والشركات العابرة للدول وللقارات؛ وبروز صراعات عرقية ولسانية وثقافية ودينية في العالم؛ فقد كان لا بد من وضع معايير عالمية لحماية التنوع الثقافي والهوياتي؛ وقد تمخض عن هذا العديد من الاتفاقيات الدولية، التي أكدت على حماية اللغات
والثقافات والهويات.
وبعد أن استعرض مجموعة من النماذج التعددية المبنية على مجموعة من المفاهيم )أصلية السكان ومفهوم الاعتراف بحقوق الأقليات المواطنة ومفهوم الاعتراف بحقوق الأقليات المهاجرة(؛ قدم النموذج المغربي المتمثل في التدرج من الاعتراف النسبي )إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 9110 ، الشروع في إدراج اللغة الأمازيغية في
المنظومة التربوية والجامعية سنة 9113 ، إنشاء قناة تمازيغت سنة 9101 ( إلى الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية “أيضا” )سنة 9100 (. وبذلك يتم الانتقال، مع النموذج المغربي، من الإنكار التا إلى الاعتراف النسبي إلى الاعتراف الدستوري.
لكنه لاحظ أن النموذج المغربي لا زال يطرح، حسب منطوق الدستور الجديد، مجموعة من الإشكاليات )أهمها إشكالية الهوية وإشكالية هذا النموذج نفسه(. وبذلك نكون أمام مجموعة من الاختيارات القانونية والسياسية والتدبيرية والبيداغوجية التي لابد منها.
فهذا النموذج التعددي المغربي يتوقف )خطابي ا ( عند حدود الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؛ وذلك بوصفها إرثا مشتركا لجميع المغاربة )عرب وأمازيغ(؛ وعند حدود الاعتراف الدستوري )دون القانوني لحد الآن(؛ وذلك بالتصديق على المكانة الرسمية للغة الأمازيغية للدولة المغربية بعد العربية )عبارة أيضا الواردة في الدستو ر ( وليس إلى جانبها؛ وعند حدود الإقرار والتبني الصريح للتعددية الثقافية في المناهج التربوية؛ ولكن
دون اتخاذ أية مبادرة صحيحة في هذا الاتجاه.
بينما يستلزم الأمر الإقرار الصريح بإيجاد نظام تعليمي يأخذ بعين الاعتبار مكون اللغة الأمازيغية؛
والإقرار والتبني الصريح لتعددية إعلامية محسوبة؛ وذلك من خلال إنشاء قناة أمازيغية وإذاعات أمازيغية محلية موجهة أساسا إلى الناطقين بها؛ واستعمال اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في المجالات الرسمية )المجالس البرلمانية، المجالس البلدية، والمجالس النيابية والمؤتمرات الرسمية إلخ…(؛ وفي كتابة النصوص القانونية، ونصوص الأحكام، والنصوص التشريعية، والمراسلات، والوثائق الرسمية كجوازات السفر والبطائق الوطنية والطوابع البريدية والملصقات إلخ…؛ وفي المنتوجات التكنولوجية وغير التكنولوجية المنتَجة داخل البلاد أو التي يتم استيرادها من الخارج؛ وفي الإدارة والمقاولات والعلاقات العامة والعقود وحل المنازعات المرتبطة بمشاكل العمل وغيره إلخ…؛ وفي جميع المرافق والفضاءات العمومية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية ومؤسسات الصحة والقضاء والإدارة لما في ذلك من أثر إيجابي على مصالح الناس وصحتهم.
وفي الأخير أثار الأستاذ إشكالية “الشراكة والتمثيلية” التي من شأنها أن تعزز ديمقراطية النمودج المغربي؛ بحيث أبرز كيف أن اعتبار الأمازيغية تراثا لكل المغاربة يجب أن لا ينسينا أن من المغاربة أيضاً من يخاصم هذا التراث ويتمنى زواله؛ ولذلك يفترض تمثيلية للفاعلين في هذا المجال، وعلى الفاعلين الأمازيغ أن يفرضوا أنفسهم داخل اللجان
التقريرية والاستشارية.
5 ? وفي ما يتعلق بموضوع: “الأوراش الكبرى لما بعد الترسيم”؛ أكد الأستاذ أحمد عصيد في مستهل كلامه على أن الدستور الحالي دستور محتشم ومراوغ؛ بينما كان صلب مطالب الحركة الأمازيغية يتمثل في المناداة بالتنصيص في الدستور على الأمازيغية في شموليتها، أي على الأمازيغية كلغة وهوية وقيم )قيم الحرية والمساواة والعدل وغيرها من القيم المتضمنة في المواثيق الدولية والمتواجدة في ثقافتنا الأمازيغية(. إننا، يضيف السيد المحاضر، أمام دستور متناقض وأمام تصرف الدولة؛ بعد الإعلان عن الاعتراف بالأمازيغية؛ بشكل لا يتطابق فيه الخطاب والفعل. إضافة إلى ذلك نجد أنفسنا أمام خطاب رسمي مضحك، لكون المكونات الحكومية بمثابة جزر )فإذا كان مثلا السيد وزير الثقافة لا يرى حدودا للفن فإن ثلاثة وزراء من حزب العدالة والتنمية صرحوا بآراء مناقضة تماما
وأكدوا على ضرورة وضع حدود للفن(.
إن التفكير في الأمازيغية، يقول الأستاذ أحمد عصيد، ينبغي أن يتم بتفكير شمولي. فمن حيث المبادئ والمكتسبات ينبغي التشبث بمبدأين: الأول يتمثل في التوابث الأربعة، أي في عدم التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية بمبادئها الأربعة: )التعميم، الإجبارية، المعيرة، كتابة الأمازيغية بحرفها الأصلي: تيفيناغ( إنها مكتسبات لا ينبغي التراجع عنها. وتجدر الإشارة إلى أن رفض تيفيناغ ليس سببه صعوبة تعلمه؛ بل اعتباره، من طرف الخصوم، مرتبطا بماضي
الأمازيغ وبهويتهم. والمبدأ الثاني يتجلى في كون الأمازيغية في التعليم ليست فقط لغة بل هي أيضا قيم
من شأنها أن تساهم في تحرير المغاربة. ومن حيث التدبير الديني تنبغي الإشارة إلى أنه شرقي وليس مغربيا. ومن حيث التدبير الإعلامي فالضرورة تستلزم تحديد النسب المئوية للغات وخاصة الأمازيغية والعربية، كلغتين رسميتين واللتين ينبغي المساواة بينهما، بحيث تحدد نسبة % 31 لكل منهما، النسبة التي طالما طالبت بها الحركة الأمازيغية في حين يخصص ما تبقى للغات الأجنبية .
وفي الأخير دعا الأستاذ أحمد عصيد إلى ضرورة تحرك الحركة الأمازيغية على مختلف الواجهات وتعاملها مع حلفاء أينما كانوا سواء داخل الحكومة أو في المعارضة أو على مستوى المجتمع المدني.